لماذا فشلت وستفشل الدعوة إلى التجديد الديني؟
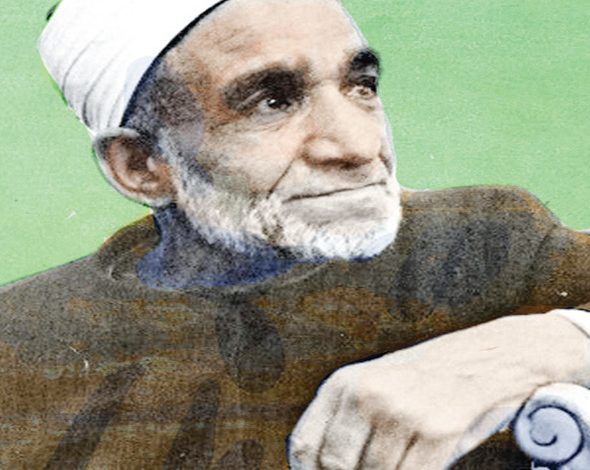
بقلم / حاتم السروي
هذا السؤال الذي جعلته عنواناً للمقالة، إجابته قد تتطلب منا العودة إلى الوراء إثنا عشر قرناً ويزيد من عمر الزمان، فإنه بعد الفتنة التي حدثت في عهد المأمون ومن بعده المعتصم والواثق وهي فتنة خلق القرآن. جاء الخليفة المتوكل فأخرج الإمام أحمد بن حنبل من محبسه فقد كان محبوساً في السجن ثم حبسه الواثق في داره وفي السجن جلد وعذب وكان مذهبه مذهب السلف وهو التمسك بالآثار والنصوص والأحاديث إن صحت. وما لم يتكلم فيه الرسول ولا صحابته كان يكف عنه وكان يغلب عليه الحديث وأصوله في الفقه هي نفسها أصول إمامه الشافعي وكان في صفات الله يفوض فإذا سأله السائل ما تفسير “الرحمن على العرش استوى” قال تفسيرها قراءتها.
ثم مات الإمام أحمد وكان لا يزال في المعتزلة رمق، فإنهم لم ينتهوا إلا في القرن السادس الهجري، ومنهم خرج أبو الحسن الأشعري وكان فيهم رأساً، ثم بدا له أن يؤسس مذهباً وسطاً يوفق فيه بين المعتزلة ومذهب أهل السنة؛ ومن هنا كان المذهب الأشعري الذي حاول التوفيق بين طرفي الصراع وهو الصراع الذ كان حادًّا وعارمًا كما يبدو لنا من التاريخ، فخرج المذهب الأشعري خليطًا من عقلانية المعتزلة والتزام أهل الأثر بالنص، ولقي هذا هوىً عند الشافعية فإن مذهبهم الفقهي كان هو الآخر خليطًا بين الأحناف أهل الرأي والقياس، وبين المالكية وإمامهم كان صاحب حديث وهو مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة الذي صنف الموطأ.
وظل المذهب الأشعري ينتشر ويزدهر بفضل انضمام بعض الشخصيات العلمية الكبيرة له من الفقهاء والمحدثين، وبفضل تأييد بعض الحكام ودعمهم، وبفضل مرونته ولا شك فهو مذهب انسيابي لا يغضب أحداً!. وظل طلاب الفقه يحرصون على تقليد الشافعي في الفقه والأشعري في الاعتقاد، وكان للأحناف مذهبٌ في الاعتقاد يسمونه الماتريدية نسبةً إلى (أبي منصور الماتريدي وهو من علماء ما وراء النهر وقد شرح كتاب “الفقه الأكبر” في علم التوحيد لأبي حنيفة) وإنك لا تجد فرقاً يذكر بينه وبين الأشاعرة فاختلافه عنهم يعتبر يسيراً ويمكن جبره بسهوله، ولكن يبدو أن الأحناف كانوا حريصين على تمييز أنفسهم لاعتبارات التعصب المذهبي واختلافهم مع الشافعية، وقد عرفوا أو عُرِفَ أكثرهم باعتدادهم بالمذهب، حتى لقد قال الكرخي: “كل أثر ليس عليه أصحابنا فهو منسوخ أو مؤول”!.
ورغم توافر آلة الاجتهاد عند علماء الشافعية الكبار أمثال (العز بن عبد السلام وسراج الدين البلقيني وأبو شامة صاحب كتاب الباعث في إنكار البدع والحوادث حتى أن الفزاري قال عنه: ”عجبت لأبي شامة كيف قلد الشافعي”) رغم بلوغهم هذه الدرجة فإنهم لم يجتهدوا ولم يخرجوا عن قول الشافعي رحمه الله لأن عصرهم كان يرفض الخروج على المذاهب الفقهية الأربعة، وكان الحكام والأغنياء والموسرون وأصحاب الجاه يبنون المدارس ويرتبون الراواتب لفقهاء المذاهب، فلو تخلى الفقيه عن مذهبه الذي تعلمه وأفتى به لتخلت عنه الدنيا وتخلى عنه العامة والحاكم وخُرِب بيته.. ومع هذا تجد في ثنايا الكتب وبين السطور خروجات عن المذهب الشافعي في الفقه والأشعري في الاعتقاد..فتجد الغزالي مثلاً يود لو كان مذهب الشافعي في طهارة المياة مثل مذهب مالك، فإن الشافعي يشترط لبقاء وصف الطهارة في المياه إذا وقعت فيها نجاسة أن تكون المياه قد بلغت قلتين وهما خمسمائة رطل عراقي تقريباً، فيما كان مالك أكثر تيسيراً حيث قد ذهب إلى أن الماء قليله أو كثيره لا ينجس إلا إذا غيرت النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه..
وفي الاعتقاد تجد فخر الدين الرازي وهو من كبار الأشاعرة يورد إشكلات على نظرية الكسب الأشعرية ويقول في النهاية: ” وعند التحقيق يظهر أن الكسب إسمٌ بلا مسمى” ثم نجد إمام الحرمين الجويني يعدل نظرية الكسب ويقول أن الله يعلم الذنب قبل وقوعه بعلمه السابق المحيط بكل شيء والأزلي قبل كل شيء، ولكنه لا يجبر العبد عليه؛ فللعبد قدرة تؤثر في مقدورها وبهذا أثبت للعبد القدرة ولله سبحانه القدر، فإن كل شيء بتقديره سبحانه، ومع هذا فكيف يؤخذ العبد بالذنب لو لم يكن له اختيار ولا قدرة؟؟ ولو قلنا أن القدرة تقارن الفعل ولا تؤثر فيه فهذا ليس بشيء، ولكنها حيلة من حيل الأشاعرة وانعكاس لمذهبهم التوفيقي الذي يحمل ما يثير العجب بقدر ما يحمل ما يثير الإعجاب.
وفي الصفات الإلهية تجد الأشاعرة بين التفويض كما هو عند أحمد بن حنبل وبين التأويل، فإذا ما ورد في الأحاديث على وجه القطع أن الله في السماء، ترى بعضهم يقولون هو كما ورد ولكن السماء ليست مكانًا بل إن لها هاهنا معنى لا نعرفه، وإنما يعرفه الله وحده، والله أعلم بذاته وصفاته، وما علينا إلا التسليم، وفي المقابل تسمع بعضهم يقول إن السماء هنا معناها السمو ونحن نثبت صفة العلو للباري جل شأنه على أنه علو المكانة وارتفاع الرتبة، ثم يواجههم إشكال وما أكثر الإشكالات التي تواجههم، وهو إشكال يُثار تلقائياً كلما تأولوا معنى السماء وقالوا أن الله ليس له مكان، وهذا الإشكال بسيط بيد أنهم لا يستطيعون دفعه إلا بشق الأنفس، فما هو؟ لا شيء غير أن أي إنسان سنياً كان أو غير سني، مسلماً كان أو نصرانياً عندما يدعو الله ينظر إلى السماء ولا يتلفت يميناً ولا شمالاً، ولا يستطيع دفع هذه الضرورة التي تدفعه تلقائياً إلى النظر للسماء ورفع يديه إليها. ويحكى عن الجويني أنه لما ذكر الهمداني عنده هذا الإشكال لطم رأسه وصرخ وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني..
ثم خبا ضوء الأشاعرة وانفض سامرهم، والأمر نفسه كان ينطبق على المذاهب، وانكب الفقهاء على قراءة المذاهب -دون التزام بمذهب معين- والترجيح بينها وبدأوا يتركون التقليد لأنه أضعف الفقه ونفر منه الناس وجعلهم يدخلون أبنائهم في المدارس العمومية نظراً لصعوبة الفقه ومادة التوحيد وسائر العلوم الشرعية التي جعلها أصحابها طلاسم لا تفيد في معرفة الدين ولا تنفع صاحبها في دنيا الناس.
وترك علماء الاعتقاد مذهب الأشاعرة والجدليات الغريبة بين الفرق وبدأنا نستشعر نهضة علمية إسلامية، ثم تراجع كل شيء وعدنا إلى نقطة الصفر وتم إجهاض رسالة وطريق الإصلاح بسبب نفر من العلماء الجامدين، وأيضاً بسبب بعض أصحاب السلطة الذين رأوا في المصلحين خطراً عليهم فكالوا لهم التهم وأتعبوهم بالسجن والتضييق واضطروا كثيراً منهم للسفر والهجرة، ثم بَهَت التعليم الديني في مصر ودخل في طور الخمود والركود وتراجع كثيراً، وظن ضعفاء البصيرة وبعض السطحيين أن سبب ضعف الحركة العلمية هو ترك تقليد المذاهب وعدم الاهتمام بمذهب الأشعري إلا في إطار كونه تراثاً علمياً وهو بالفعل ليس أكثر من ذلك، فكان أن أعاد هؤلاء فكرة التمذهب وجعل مذهب الشافعي أو غيره كالدين، وبهذا يصبح لكل منطقة دينها، فدين أهل الصعيد المالكي، ودين أهل الوجه البحري الشافعي، ودين سكان القاهرة هو الحنفي، وتعصب البعض للشافعي حتى كأن للإسلام رسولان فأولهما هو سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وثانيهما هو محمد بن إدريس الشافعي!!.
حسناً هل لنا أن نسألهم وهم يعرفون أن المذاهب لم تستقر ولم تنتشر ولم تتمكن إلا بعد وفاة أصحابها وبعد تدوينها في الكتب يعني في القرن الرابع الهجري فإن قالوا في الثالث قلنا لا بأس فهل معنى هذا أن المسلمين كانوا على ضلالة قبل المذاهب الفقهية؟؟ وهل كانوا على ضلالة قبل مذهب الأشعري؟ وهل كانوا على ضلالة قبل الطرق الصوفية التي بدأت بوادرها في القرن السادس الهجري وانتشرت في القرن السابع؟؟ وإذا لم يكن التعصب للمذاهب بدعة فما هي البدعة؟ إنهم يجعلون إمام المذهب كصاحب الشرع فكيف يُقبل هذا؟ لكل ما سبق أقول وقد أكون مخطئاً أن الوضع الحالي الذي عليه المهتمون بالعلم الديني والذي ينبئ عن تقليدٍ عقيم وعن فهمٍ سقيم وتهميش لفقه المقاصد وجوهر الرسالة المحمدية وفي الوقت ذاته عدم فهم الواقع كما ينبغي وينبي قبل هذا عن هزال المعرفة الدينية، إن هذا الوضع لن يصل بنا إلى أي تجديد من أي نوع، والحل في يد الأزهر الشريف فليس لنا مؤسسة دينية ترعانا غيره، فإما التجديد الحقيقي وإما الهزيمة الفكرية الحقيقية.
المراجع :






